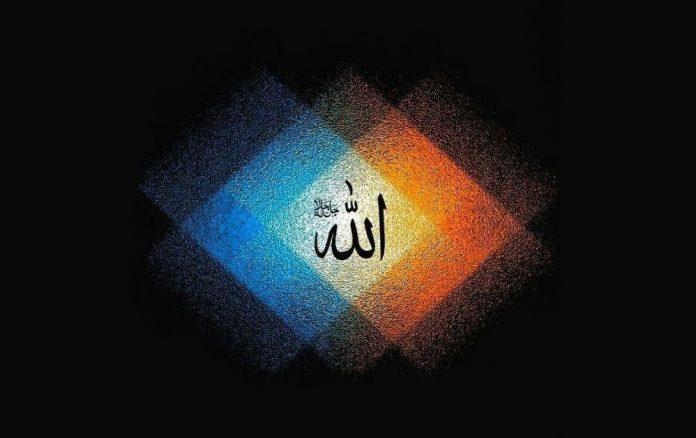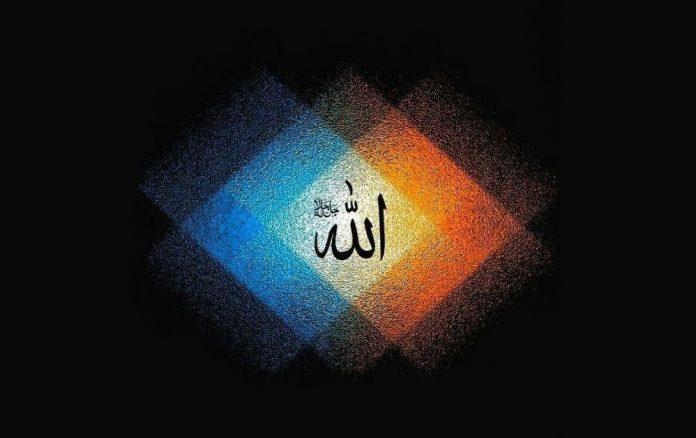قد يرى بعضنا أن العنوان هو أحد المحرمات، لكني سأطرح سؤالًا هنا سيساعدنا على المضي قدمًا في بحثنا: هل اسم الله إشكالية فكرية أم فلسفية أم إنسانية أم لغوية أو دينية فقط؟
يدّعي كثيرون وجود الله ويرفضه كثيرون. يقدّسه كثيرون إلى مستوى تحريم نُطق اسمه، ويرفض كثيرون تقديم تعريف له مُستبدلين باسمه صفات. مثلًا، يحسب رينيه ديكارت الله فكرة تنتجها النفس من ذاتها في الذهن، ويحسبه إيمانويل كانط فكرة ترنسندنتالية (فلسفة متعالية) تنبع من طبيعة العقل ولا تأتيه من أية جهة غريبة عنه. أما هيجل فيحسبه فكرة عميقة عالمية تقود تاريخ العالم وتحركه في أطر محددة، ويراه نيتشه مجرد شخص سردي مات في ضمير أوروبا منذ زمن طويل.
وعليه، يعتقد كثيرون من أبناء جيلي أنه لا يحق لأي شعب أو دين أو أيديولوجية أن يحتكر معنى الله أو مفهوم الله أو اسم الله له وحده دون الآخر. فالجميع أسهموا، بحسب رأيهم، في صياغة مفهوم متراكم لمعنى اسم الله، وهو محصلة إسهامات بشرية متراكمة بدأت منذ فجر التاريخ، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. كما أنه يستحيل في رأي كثيرين تقديم لمفهوم الله، فمعنى الإلوهية ينتشر في كل الثقافات دون استثناء. فلكل أيديولوجية وجماعة تعريفها الخاص عن الله والذي يُستخدم في إطار ما وعلى نحو تواتري من جيل إلى جيل ويتضمن صفات وأسماء وأشكالًا ميتافيزيقية لذلك الإله المزعوم.
كما يعتقد العقل الجمعي الفلسفي العام أن لكل عقل متفلسف الحق أن يكون فكرته الخاصة عن الله على المستوى المفاهيمي والأنطولوجي دون أن يضع في الحسبان التصورات المحيطة. فالله عندهم ليس كيانًا شخصيًا خارجًا عن الإنسان، بل قيمة ثقافية من نوع ما يتغير شكله في محيط الثقافة واللغة والمكان والزمان. ولا يعني هذا أنه ليس كيانًا حقيقيًا، بل ليس ذلك الكيان الذي يمتلك صفات وسمات موضوعية مميزة عن الواقع الحضاري الثقافي.
وعليه يصبح البحث في ماهية الله، أو معنى الله، بحثًا ثقافيًا وسجالًا فكريًا ونزاعًا لغويًا بعيدًا كل البعد عن الأطروحة اللاهوتية الحقيقية، لتصبح صفاته وسماته عبارات غامضة نسبية يتغير معناها بتغير الزمان والمكان والحضارة والثقافة. فماذا نعني بأبوة الله للعالم؟ أو ماذا نعني بأن الله يحب كل البشر؟ ما معنى أن الله يهتم بنا ويسمعنا؟
جميعها أسئلة تحمل في ذاتها تواترًا وجوديًا معقدًا ما بين عقول كثيرة لا تملك مرجعية يمكن الاحتكام لها. فكلمة “الله” تبدو للوهلة الأولى ذات معنى متفق عليه إلى أن نبدأ بالبحث عن مضمونها في اللغات والثقافات لنكتشف أن المعنى واسع جدًا ومركب بطريقة يصعب تصورها أو تتبع تنوعاتها. لذلك نجد بعضهم يحسب الله بطلًا دينيًا من نوع ما تهمُّه عودة الأديان للتحكم في مصير البشر وجوديًا وفي ما يخص طريقة الموت، في حين أن بعضهم يرى أن الله والقتل والعنف وجهان لعملة واحدة، ويرى فريق ثالث أن الله يقع خلف كل نزاع سياسي يحدث في العالم. وهكذا أصبحت أسئلتنا عن الله وعلاقته بكل عناصر الحياة تساؤلات عميقة ينبغي إدراكها لندرك هويتنا الحقيقية.
وعليه صرنا نطرح على أنفسنا تلك الأسئلة البديهية التي اعتدنا عدم التفكير فيها، لكنها اليوم صارت الأسئلة التي ينبغي أن نتساءل عنها. فما علاقة الله بالسلطة والجمال والفن والعلم والموسيقى والرياضة والفلك والأخلاق والجنس والموت والفضيلة والولادة؟ فالأفكار تصبح أكثر صعوبة ولا تقبل المراجعة كلما بدت بديهية أكثر. فالعقل البشري لم يعتد التفكير في المسلمات والبديهيات، بل هي مقبولة وسليمة في العقل الإنساني العام دون تفكير أو تفكر. وتنطبق هذه البديهية على الوجود الإلهي الذي يُعد من البديهيات في أوساط الشرق الأوسط حيث حُرمنا من التأمل في معنى الإلوهية ودلالاتها الوجودية.
وعليه، فإشكالية اسم الله بدلالاته العميقة يتحرك في أبعاد لغوية متنوعة ينبغي إدراكها في سياق بحثنا حول الله.
فجميعنا ندّعي أننا نعرف “الله” أكثر من ذلك الآخر الذي يدَّعي الآخر بدوره معرفة “الله” أكثر منا نحن الذين ندّعي معرفته.
وعليه، نقدم جميعنا تصريحات لغوية نحاول فيها وصف “الله” محتكرين المعنى الحقيقي في لغتنا التي تُقصي الآخر. واللافت أن جميع تلك التعريفات هي تصريحات غير قابلة للاختزال في إطار واحد متفق عليه يجمع ما بيننا في سياق واحد. ليصبح “الله” مادة معرفية بلا روح، بل مجرد تعريف توافقي يلائم ثقافة معينة حاضرة محددة.
مثلًا، وصفه أرسطو بأنه “المحرك الأول”، والعقل الذي يعقل نفسه، أو بلغتنا الحديثة هو التفكير الذي يفكر في نفسه. ويعود سبب هذا التقديم الاستثنائي لماهية الله في فلسفة أرسطو إلى هيمنة نظرية “المُثُل” الأفلاطونية على المزاج الفكري العام الحاكم للمنظومة الفكرية منذ أرسطو.
من جهة أخرى، يقدم الفكر الإسلامي تعريفًا خاصًا لله في إطار الكيان الواحد الصمد ذي الوحدانية المطلقة والمنزه من التجسد، والحاضر معنا بأسمائه التسعة والتسعين، وليس صفاته التي يدور حولها الكثير من النقاشات والأطروحات.
ولدى الكلام عن مذهب وحدة الوجود، نجد أنه يرى أن الله في طبيعته والكون في مضمونه شيء واحد لا يمكن فصلهما. وترى الحلولية الله مفهومًا متميزًا حالًا في الأشياء، وفي كل شيء وأي شيء.
وفي سياق آخر، قدَّمت الربوبية مفهومًا أنطولوجيًا لهذا الكيان غير المرئي على أنه الخالق الذي لا يطلب علاقة بالبشر؛ فهو خلق القانون والانتظام والنظام، وانسحب وترفَّع جدًا عن التعامل مع كل ما هو بشري.
لكن ما يميز إله الأديان الإبراهيمية، إن جاز التعبير، بصيغتها التنظيرية هو أنه يريد ارتباطًا بالإنسان، ويستطيع إنشاء علاقة به. ويختلف هذا عن إله الفلاسفة والأيديولوجيات التي قدَّمت كائنًا موجودًا عبثيًا لا يُبالي بشيء تقريبًا، أو كائنًا كان موجودًا لكن الإنسان أماته، ولم يعد له وجود كما قدمه نيتشه الذي أثر في الفلسفة الأوروبية.
وفي إطارات مختلفة، نراه ليس إلا فكرة متعالية لذلك الأب البيولوجي كما رآه سيجموند فرويد، أو فكرة بشرية جرى تخزينها في اللغة الإنسانية العالمية بفعل السنين الطويلة المتراكمة على نحو يُضفي عليها نوعًا من الاستقلالية والتجرد.
غير أن ما يهمني في هذا السياق هو كيفية تعامل المسيحية مع مفهوم الإلوهية، والكيفية التي قدمته بها للعالم.
التعريف المسيحي الأنطولوجي هو أن الله كائن روحي شخصي يتمتع بالوعي والإدراك والفهم والتفكير. إنه الإله الواحد الثالوث (الله الواحد في الجوهر والثالوث في الأقانيم) الذات (أي ما له إرادة عاقلة وعقل يريد) المتجسد (أي ظهر في الجسد) ضروري الوجود (ويجعله هذا يعقل نفسه ويعقل المحيط به أيضًا) المكتفي بذاته (أي القائم بذاته، ووجوده ليس معتمدًا على غيره وليس مكتسبًا من كائن أو شيء قبله، أو مستعارًا من آخر). إنه الخالق الضابط، والأب المحب، والرب القدوس الحق الجميل. وهو كلي الصلاح والمعرفة والقدرة (يعرف ما يريده، ويريد ما يقدر عليه). فليس كل ما يعرفه يريده، وليس كل ما يقدر عليه يريده. ولا تنتهك قدرته حرية الإنسان المحدودة التي منحها الله بنعمته السابقة. يدير مقاصده الكبرى رغم حرية الإنسان، وليس بانتهاكها.
وهكذا تصبح كل صفاته وأقواله وأفكاره وأفعاله نابعة من طبيعته لا مشيئته، وهذا اختلاف جوهري عميق ينبغي إدراكه. فهو لا يفعل شيئًا خارج صفاته أو طبيعته. وهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء دون اعتبار لطبيعة ذلك الشيء ومدى اتساقه مع طبيعته الإلوهية.
بكلمات أخرى، هو لا يستطيع أن يفعل ما يستحيل جوهريًا، أي ما يملك استحالته في ذاته، فلا يتوافق مع طبيعته الإلوهية القائمة في انسجام أزلي لصفاته الفاعلة الإيجابية الحقيقية.
فالله لا يستطيع أن يفعل الشر في إطار الخطية، كما أنه لا يستطيع أن ينكر ذاته ويعيش في حالة غموض إلى الأبد، ولا أن يخدع الإنسان ويخلف بوعوده معه. وليس هذا ضعفًا، بل هو اتساق مع طبيعته المنسجمة في ذاتها دون تناقض.
غير أن هناك تعاملات سرية لله لا يمكن أن يدركها العقل الإنساني مهما اجتهد في أحكامه ووعيه. فإن كان الله لا يصنع الشر في إطار الخطية، لأنها خارج طبيعته وصفاته المنسجمة في ذاتها، فلا يعني هذا أنه لا يستطيع أن يؤدب شعبًا أو فردًا من باب التوجيه والتهذيب والإعداد والتطوير، إذ له كل الحق في تلك التدخلات الأبوية التي تؤول دائمًا إلى خيرنا كما هي الحال في نموذج الأب البيولوجي على أقل تقدير. فابني لا يدرك سبب تعريضي إياه للحرمان والخسارة أحيانًا، ولتحمل نتائج قراراته أحيانًا أخرى. فأبدو في نظره إنسانًا قاسيًا لا مباليًا بمشاعره وتوقعاته بوصفي أباه.
فإن كانت مواقف الله وأفعاله نابعة من قدرته لا من طبيعته، فسوف يجعله هذا قادرًا على فعل الشيء ونقيضه دون اعتبارات لشخصيته، فيسقط في عدم الاتساق الذي يدمر فيه إلوهيته.
بعض التناقض…
أعتقد أن المشكلة الحقيقية في الحوار الفكري الراقي حول مسألة الله ما بين المؤمنين بوجوده وبين مَنْ لا يؤمنون بوجوده هي أن لكل منهم منطقه الخاص في رؤية العالم بصفة وحدة متكاملة. ولا أدَّعي أن أيًا من الفريقين يمتلك منطقًا أفضل من الآخر؛ إذ أنني لا أمتلك تلك الصلاحية لتقييم أي من تلك الأيدولوجيات. وإن كنت ممن يؤمنون بوجود الله حاسبًا إياه منظورًا أفضل للحياة، لكنني أمتلك حق التحفظ على تلك القراءة التي يتمسك بها مَنْ يرفضون وجود الله بسبب التناقضات الوجودية التي يعيشونها في إطارات مختلفة.
فتارة نراهم يرفضون التصميم والمنطق التصميمي في بنية الكون والطبيعة، ثم يتمسكون بذلك التصميم ويستخدمونه في إسقاطات أخرى.
تارة يرفضون الاستدلال على ضرورة وجود مسبب أول للكون والحياة الإنسانية بسبب غياب الأدلة القاطعة على وجوده، ثم يستخدمون المنطق الاستدلالي نفسه في تكوين تصوراتهم حول إمكانية الانتخاب الطبيعي أن يوجه التطور في محطات صريحة في التاريخ الزمني انطلاقًا من الأصل المشترك الذي تعرض لطفرات عشوائية.
تارة يكون لهم الحق في التشكيك في وجود الله بوصفه استدلالًا قابلًا للشك فيه بحسب طبيعة المنظومة المعرفية ومحدودية العقل الإنساني، ثم يحسبون أن استدلالاتهم على عدم وجود الله هو تصريحات لا تقبل التشكيك ولا حتى المساءلة.
تارة نراهم يرفضون موضوعية الأخلاق في الإطار الإيماني، ثم يستعيرون تلك الموضوعية حتى تستمر حياتهم استمرارًا عقلانيًا موضوعيًا مقبولًا، رافضين الأخلاق النسبية التي يمكن أن تدمر حياتنا.
لذلك أعتقد أن المشكلة الحقيقية ليست في غياب المنطق لدى رافضي وجود الله، بل هي في شبه المنطق العام الحاضر في تناقضات وجودية يتمسكون بها.
وأفضل تشبيه لهذا التصور المتناقض في ذاته هو ما قدمه الفيلسوف تشيسترتون في كتابه “الإيمان القويم”، إذ يقول بإمكانية صدفة أن تُدخِل عصا مستديرة المقطع في فتحة مستديرة الشكل؛ فهذا تصور منطقي مشروع. أما إذا دخل مفتاح ذو تفاصيل متعددة في فتحة قفل متعدد التفاصيل أيضًا، فلا يمكن أن يكون الأمر مجرد صدفة، فهذا هو مفتاح القفل دون أدنى شك.
فإحدى أبرز المشكلات مع مَنْ يرفضون وجود الله هي احتكامهم للصدفة العشوائية في إطار تبرير وجود الكون والحياة الإنسانية. ثم أراهم في مواقف مختلفة يرفضون مفهوم الصدفة لتبرير وجود الأشياء في مضمونها العام في الإطار الوجودي.
داني سمارنه
كلمة “الله” تبدو للوهلة الأولى ذات معنى متفق عليه إلى أن نبدأ بالبحث عن مضمونها في اللغات والثقافات لنكتشف أن المعنى واسع جدًا ومركب بطريقة يصعب تصورها أو تتبع تنوعاتها