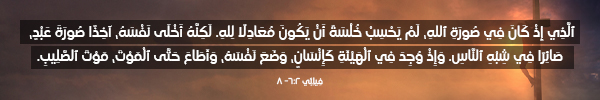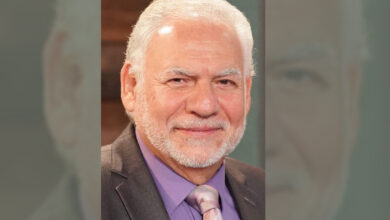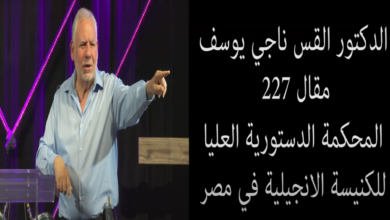جريدة الطريق
رأس الحكمة | مقال مارس 2024 العدد 222

د. ناجي يوسف
عجيب هذا الشعب المصري الطيب المسكين، شعب لا يرى أبعد مما تحت رجليه، شعب يثار بالعواطف والشعارات والتمنيات والغيبيات ولا يفكر في أبعد من الحدث الذي يمر به. وحيث إن الوسواس الخناس يعلم صفات هذا الشعب جيدًا لذا فهو يتعامل معه على هذا الأساس، ويستخدم قادته في تنفيذ مشيئته الشيطانية بخططه المحكمة المدروسة ويوقعهم في شر أعمالهم ويضيق عليهم الخناق حتى يلجأوا إليه لطلب المعونة والنجدة منه، وهو الشرير الذي لا يرحم ولا يشفق فهذه ليست من خصاله. سمعتُ رئيس وزراء مصر يعلن بسرور عن صفقة العمر، وعن أكبر استثمار ستقوم به مشكورة، من الشعب والحكومة المصرية، دولة الإمارات العربية، أطال الله أعمار قادتها وأكثر من ثرائهم وعطائهم بغض النظر عن دوافعهم لعمل ذلك.
لستُ أدري لماذا عندما سمعتُ أخبار هذه الصفقة من السيد رئيس الوزراء مر بي شريط العطاء المصري للعالم أجمع على مر العصور منذ أن خلقها المولى تبارك اسمه ونزل إليها نبي الله إبراهيم، ونبي الله يعقوب والأسباط، ونزل إليها أيضًا سيد الأنبياء وخاتم المرسلين منه سبحانه، المسيح يسوع تبارك اسمه، وعائلته المقدسة. كانت مصر ملجًا ومناصًا للفارين من شعب إسرائيل بسبب المجاعة التي اجتاحت الأرض كلها في عهد الفرعون الذي جعل من يوسف الصديق، العبد السجين يومئذٍ، الرجل الثاني في البلاد، لا يرفع أحد يده أو رجله إلا بأمره وموافقته. وجعل الله من مصر أيضًا ملجأً وملاذًا للباقين في أورشليم في أيام إرميا النبي في حكم صدقيا ملك إسرائيل الشرير. وهكذا كانت ولا زالت مصر ملجأً وملاذًا للمهجرين من بلادهم بسبب الحروب أو بسبب قلة ذات اليد سواء من الإخوة والأخوات الفارين من السودان أو العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن أو ليبيا، وفوق الكل من الفلسطينيين الذين استوطنوها من عشرات السنين وتمتعوا بخيراتها وسطوا على مقاعد الطلبة المصريين في مختلف الكليات والمعاهد وغيرها الكثير. لا أدري لماذا مر برأسي هذا الشريط الطويل من الأحداث وتساءلتُ: لماذا وصلت مصر من الانحدار والانحطاط بين الدول للدرجة التي تعطي فيها للدول الأخرى أجزاء من أرضها وترابها إما لتضمها تلك الدول إلى أرضها وسيادتها كتيران وصنافير اللتين أعطيتا للسعودية، أو يشتري الأغراب عنها شركاتها ومصانعها وأراضيها ومدنها، أو يأخذون منها حق الانتفاع بأملاكها وممتلكاتها للدرجة التي تجرأت فيها أصغر دول العالم “قطر” على أن تطلب حق إدارة قناة السويس التي مات آلاف المصريين في حفرها وملئها واستخدامها لمئات السنين، الأمر الذي لم نسمعه أو نشاهده حدث في أية دولة عربية أخرى، حتى تلك الدول العربية الصغيرة والفقيرة والتي لا تقارن بمصر من ناحية تاريخها وآثارها ومواردها الزراعية والصناعية والمواد الخام في جبالها ووجود أهم مجرى مائي في العالم كله حتى اليوم ويجري على أرضها، أي قناة السويس؟
سألتُ نفسي: لماذا مصر بالذات التي يحدث بها كل هذا الاضطراب والاحتياج والغلاء المعيشي والفوضى الحادثة بها في هذه الأيام؟ وكانت الإجابة التي حصلتُ عليها من داخلي في عقلي ووجداني والأهم منهما في روحي هي أنه لا أحد في مصر يفكر فيما يحدث في مصر بطريقة روحية مسيحية كتابية لا بين المسئولين في الحكومة أو حتى الكنيسة. فبالنسبة للحكومة والمسئولين عن الإدارة الحكومية للبلاد، فإن هؤلاء لا يُتوقع منهم أن يفكروا بطريقة مسيحية كتابية حيث إنهم ليسوا بمسيحيين، وهم يؤمنون أن الكتاب المقدس قد تحرف ولعبت به يد البشر بالزيادة والنقصان، فكيف يُطلب منهم أن يفحصوا الكتاب المقدس المحرف، في قناعاتهم الشخصية والدينية، ليعرفوا منه ويفهموا ما يحدث في مصر؟ فهؤلاء لا يمكن أن يلومهم أحد، مع أنهم ليسوا بأبرياء أمام الله أو معفيين من مسئولية البحث والسؤال والحصول على إجابات روحية مسيحية، فهم مدانون إن لم يفعلوا ويلتفتوا ويقرأوا ويتعلموا الفهم والحكم الصحيح على الأمور ومعرفة الأسباب الحقيقية لكل أزمة مادية اقتصادية أو سياسية أو عسكرية تمر بها مصر، وهذه كلها مدونة في كتاب الكتب، كتاب الله الوحيد، التوراة والإنجيل، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن ما لا يمكن فهمه هو أنه حتى الكنيسة في مصر، على اختلاف طوائفها، لا تفكر سوى بنفس الطريقة التي تفكر بها الحكومات المصرية، هذا إن كانت تفكر من الأصل في حل مثل هذه القضايا والمشكلات واقتراح حلها بطريقة كتابية مسيحية إلهية مضمونة النتائج، فالكنيسة لا يمكن أن يُغفر لها الوجود في مثل هذه الحالة من السبات والنوم العميق، والتواكلية الروحية، والانعزالية الفكرية عن المجتمع المصري.
وفي رأيي الخاص أن المشكلة المادية والدينية والمجتمعية مع مصر بالذات هي مشكلة روحية في المقام الأول، مشكلة معقدة متعددة الجوانب قديمة قدم الدهر. وإليك عزيزي القارئ بعض بدايات هذه المشكلة التي أثق أن مصر لا زالت تعاني منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
أ- جانب استحواذ الفرعون القديم، مَنْ كان معاصرًا لنبي الله إبراهيم، وسيطرته على كل شعب مصر واستحواذه لنفسه على كل النساء الجميلات التي تمشي على أرض مصر، وهذا ما حدث مع ساراي امرأة نبي المولى إبراهيم عند نزوله وزوجته إلى مصر إذ يقول الكتاب: “فحدث لما دخل إبراهيم إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدًا. ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون، فأُخذت المرأة إلى بيت فرعون.”
ب- جانب الإرهاب الحكومي لعامة الشعب حتى لا يجرؤ أحد على أن يقول عكس ما يقوله الفرعون أو يقرره على المصريين هو ورؤساؤه ووزراؤه، ففي عصر ساراي وإبراهيم لم يجرؤ أحد رجال الفرعون على التفكير في الزواج من ساراي بالرغم من جمالها. وثقتي أن كل مَنْ كان حولها من الرجال كان يحلم بالحصول عليها والزواج منها، لكن مَنْ يستطيع أن يتزوج جميلة دون موافقة الفرعون، وذلك لعلمهم أنهم في النهاية من الخاسرين، ولذا فقد آثروا السكوت والتصفيق للفرعون وتهنئته بالصفقة الكبيرة التي عقدها مع إبراهيم، فقد أخذ منه ساراي امرأته وأعطاه بدلًا منها حميرًا وجمالًا ومواشي وعبيدًا وإماءً، وما أشبه اليوم بالبارحة.
ج- المشكلة الروحية الثالثة مع شعب مصر هي اتخاذهم أسهل وأقرب الطرق لحل أية أزمة يمرون بها، فعندما احتاج المصريون في القديم للقمح ليزرعوا ويأكلوا في سنين المجاعة العجاف، بدأوا بشراء قمحهم الذي أعطوه هم للفرعون، والمنتج من خير أرضهم الوفير، وبسواعدهم وعرق جبينهم هم وأولادهم، لكنهم سكتوا عن المطالبة بحقهم. ألم يكن من حق المصريين ومن واجب المسئولين عن إدارة مصر أن يوفروا لشعبهم الخبز والأكل بأرخص الأسعار دون أن يصرخ لهم الشعب ويدفع الفضة والذهب، مدخراتهم التي كانوا يحرصون على عدم فقدها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور؟ لكنهم سرعان ما قبلوا بالوضع الراهن واشتروا تعب أيديهم بنقودهم، وعندما فرغت تحويشة عمرهم من فضة وذهب، باعوا مواشيهم ووسائل معيشتهم وممتلكاتهم، ثم اضطروا لبيع أراضيهم، ولم نسمع أحدهم يقف ويفكر ثم يرفع صوته لدى الفرعون ويطالبه بأن يوفر لهم العيش الكريم لا لشيء إلا لأنهم أصحاب الأرض وأصحاب خيراتها.
د- كان أسوأ ما فعله المصريون أيام فرعون القديم هو أنهم باعوا أنفسهم عبيدًا لفرعون، ومن هنا دخلت روح العبودية للشعب المصري القديم ولا زلنا نحصد تأثيرها حتى اليوم وسنظل نحصده إلى أن يقضى ربك امرًا كان مقضيًا. وروح العبودية هذا يتحكم في الإنسان بطرق كثيرة، المهم أن يجعل الإنسان عبدًا للأشخاص والأشياء طيلة حياته:
أ- المصريون عبيد لأفكارهم وقناعاتهم الدينية، والتي من بينها أن يرفض الرجل والمرأة فكرة تحديد النسل ويظنون أن فكرة الاكتفاء بإنجاب طفل واحد أو طفلين هي فكرة شيطانية، أو فكرة مستوردة من أعداء الإسلام حتى لا يزداد عدد المسلمين في الأرض فيقوى عليهم الأجانب الكفرة غير المسلمين. العجيب أن هذا الاقتناع الخاطئ بهذه الفكرة الشريرة لا ينتشر بين الجهلة أو غير المتعلمين أو رجل الشارع العادي فحسب، لكنا لكنه ينتشر أيضًا منذ زمن بعيد بين المثقفين والمتعلمين ورجال الفكر. لا زلتُ أذكر الدكتورة عواطف، أستاذة علم التحرير الصحفي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والتي كانت تقوم بتدريسنا للحصول على دبلومة الدراسات العليا في الصحافة والإعلام. كانت الدكتورة عواطف في عداء دائم مع جيهان السادات لأن الأخيرة كانت تقوم بحملات توعية لتحديد النسل، وكانت د. عواطف تنعتها بأنها عدوة الإسلام والمسلمين لأنها تحاول أن تُضعِف الأمة الإسلامية بسبب حملاتها المستمرة للسيدات لحثهن على تحديد النسل والاكتفاء بطفل أو اثنين.
ب- المصريون عبيد للأحلام والتخيلات وتأليف القصص والحكايات التي لا أساس لها من الصحة وتصديقها والدفاع عنها والموت في سبيل تحقيقها وقتل مَنْ يخالفهم أو ينتقد أحلامهم حتى لو كان يتكلم في تخصصه. وبعدها سرعان ما ينسى شعبنا الجميل ما وعده به القادة والمسئولون عن البلاد، ولا يجرؤ أن يسألهم: أين وعودكم التي نشرتموها بيننا فصدقناكم؟ ألم يحدث هذا السيناريو مع عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك وهو حادث بيننا الآن؟ ألم تعدنا السعودية بكوبري سعودي مصري يربط بين الرياض والقاهرة ويمر فوق أو حتى تحت قناة السويس، فلا يستغرق المسافر عليه سوى ساعتين من قلب السعودية إلى قلب القاهرة؟ فأين هو هذا الكوبري؟ ألم يعدونا بمشاريع مشتركة وضخ أموال كثيرة لمساعدة مصر على سداد ديونها، فأين هي السعودية اليوم من وعودها؟
واليوم نفتح نحن المصريين الباب للدول الخارجية لتستثمر في مصر، وتبني لنا وتعمر، ونقبل بشروطها لأننا نحتاج إلى دولاراتها، فإلى متى سنظل نتسول من أصغر دول العالم أن تقف بجانبنا نحن الشعب المصري الأصيل والفقير مَنْ نمتلك ثروات في أراضينا وجبالنا ومياهنا؟ فهل الاقتراض أو الشراكة أو الشحاتة من الدول الأخرى أو البنك الدولي هو القفص الحديدي الذي أغلقنا بابه علينا وأضعنا مفتاحه ولم يعد لنا مخرج منه، ولا حول لنا ولا قوة، بل مكتوب علينا أن ننتظر حتى يلقى لنا الآخرون بفتات موائدهم لنسد جوع بطوننا الخاوية منذ سنين عديدة؟
والعجيب أن الإقراض والاستثمار والبناء والتعمير والوعود بانخفاض سعر الدولار والرخاء القادم كلها نتيجة عمل مشروع واحد، يعتمد على بناء مدينة سياحية وصناعية واحدة، في محافظة مرسى مطروح النائية، وفي قرية تسمى رأس الحكمة، فهل هذه بالحقيقة حكمة في معالجة الأمور أم أننا لا زلنا نعالج العرض لا المرض وسنظل هكذا إلى ما شاء الله؟ ألا يمكن أن ننتبه للمفهوم الصحيح لرأس الحكمة ولتعريف الكتاب المقدس لعبارة رأس الحكمة؟ إن رأس الحكمة يا سادة هي مخافة الرب، الرب إله إبراهيم واسحق ويعقوب والمسيح يسوع، حسب الجسد، تبارك اسمه. وهل يمكن أن يأتي خير من وراء أرض قرية قديمة من العصور الرومانية لم تكن تسمى “رأس الحكمة” كما هي اليوم، بل كانت تسمى “رأس الكنائس” لوجود جبل بها عليه آثار الكثير من الكنائس، وقام الملك فاروق الحاكم التركي لمصر بتغيير اسمها إلى رأس الحكمة حيث لم يكن يقبل أن يُبْني له قصرًا في أرض أسمها رأس الكنائس، فغيَّر اسمها إلى رأس الحكمة، وفقًا لرواية عبد الله أبو زوير الباحث في التراث الشعبي.
دعني أضع أمام مَنْ يهمه الأمر بضعة أسئلة للإجابة عليها أو حقائق لابد من دراستها والعمل بها: